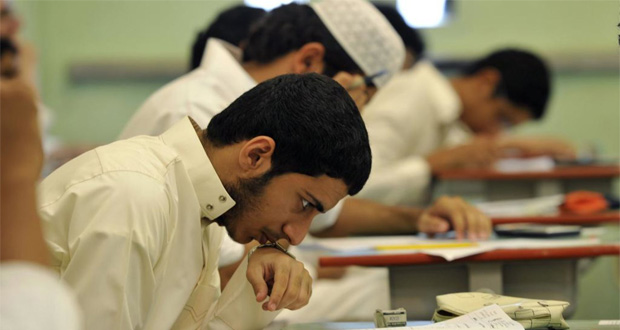تقديم:
تعتبر المدرسة مجالا حيوياً للتربية والتعليم، وزرع قيم الفضيلة والتسامح، ويعد المدرس مالكاً للمعرفة ينبغي تقاسمها مع المتعلم (الخالي الذهن) الذي يُفترض فيه الإنصات والاستماع. توجه هذه الرؤية أو القناعة معظم الفاعلين في الحقل التربوي. فمن جهة كون المدرسة فضاءً للتعلم ومجالا لممارسة المواطنة، والتعبير عن الهوية الاجتماعية والثقافية والتاريخية، أمر لاشك فيه، ولا تختلف فيه المناهج، والمقاربات البيداغوجية، والمذكرات الرسمية[1]، لكن ما يتعلق بكون المدرس محتكراً للمعرفة، وكون التلميذ وعاءً لإفراغ المعلومات، فنعتقد أن هذا الأمر ينبغي تجاوزه ومساءلة المخيلة التربوية التقليدية التي ترسخ لديها هذا الاقتناع؛ ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل وتغيير المعتقدات، وزعزعتها عبر التوعية والإعلام والتواصل، ومواكبة المستجدات التربوية.
من هذا المنطلق سنحاول إضاءة هذا الموضوع من خلال نقطتين:
- أولا: نجاح العملية التعليمية التعلمية يرتبط بمهارة الديدكتيك؛
- ثانيا: ضرورة تداخل الديدكتيك مع التمثلاث الثقافية والقيم الأخلاقية، والتربوية.
2.1 – مهارة الديدكتيك ونجاح العملية التدريسية
يمكن اعتبار العملية التدريسية عملية تشاركية لا تقتصر على المدرس بقدر ما يتداخل فيها المتعلم والمعرفة المدرسة والمكتسبة؛ وأمام هذا التداخل تصبح الطريقة العلمية، والعملية للتدريس مطلبا ملحا وضروريا لتحقيق النجاعة في الفعل التربوي؛ وفي هذا الصدد برز علم يتطرق إلى الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقف التعلم التي يخضع لها التلميذ في المؤسسة التعليمية ، قصد بلوغ الأهداف المسطرة مؤسسيا ، سواء على المستوى العقلي أو الوجداني أو الحسي – الحركي ، وتحقيق لديه المعارف و الكفايات[2] وهو: الديدكتيتك، باعتباره «تأملا وتفكيراً في طبيعة المادة الدراسية، وكذا في طبيعة وغايات تدريسها، وصياغة فرضيات خاصة انطلاقاً من المعطيات المتجددة والمتنوعة باستمرار لكل من علم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع، وهي دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي المتعلق بتدريس تلك المادة»[3].
إن الديدكتيك منهجية في التواصل وتعزيز التعلمات، وتطوير المعرفة الثقافية والفنية[4]، عن طريق بناء المعلومات، لأن المدرس مُطالب خلال الممارسة الصفية بالاهتمام بالمعارف الواجب إدماجها وتوجيه المتعلمين نحو الوجهة الصحيحة عبر إعطاء معنى وقيمة للمحتوى[5]. ويخضع الفعل الديدكتيكي لممارسة علمية دقيقة يتداخل فيها الإعداد القبلي للمدرس والمتعلم، ومجموع القيم والنظريات الأخلاقية التي تؤطر العلاقات الإنسانية وتختزل وجود الفرد باعتباره أحد أسراره. ومن ثمة نلاحظ أن الديدكتيك بقدر ما هو علم ينظم عملية تمرير المواد المدرسة بطريقة بيداغوجية تربوية بقدر ما يستضمر تمثلات قيمية.
إن العلاقة التي تربط المدرس بالمتعلم وبالمعرفة رسم مجال اشتغالها الديدكتيك في خطاطة نموذجية من خلال شكل هندسي يسمى المثلث الديدكتيكي:

ويختزل هذا المثلت علاقة تفاعلية بين أضلاعه الثلاث، تقوم على أدوار مختلفة لمكونات المثلث:
- المادة (المعرفة): ملاءمتها للتوجهات التربوية، والدينية ، والثقافية والاجتماعية؛
- المدرس: الحافزية، والقدرة على الاندماج في النسق التربوي العام؛
- المتعلم: الرغبة والقدرة على المسايرة.
ويعود الاهتمام بديدكتيك المواد والتخصصات بصفة عامة منذ الستينيات من القرن الماضي بمناسبة إصلاح الرياضيات العصرية وقد شكلت هذه الخطوة ثورة حقيقية في نظام التعليم[6]، ويعود الاهتمام به في السياق التربوي والتعليمي المغربي إلى ما شهدته المناهج والبرامج التعليمية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الجديد، من تجديد وتطوير اقتضيا مواكبتهما بأبحاث ودراسات وأشغال تطبيقية استهدفت ما يأتي:
- الملاءمة الجيدة لهذه المناهج والبرامج مع وضعيات التدريس الجديد، والأدوار المسندة إلى كافة أطراف العملية التعليمية والتعلمية؛
- المعالجة الناجعة للمعضلات والإشكالات الناجمة عن أنماط التجديد والتطوير والتغيير في جوهر العملية التعليمية والتعلمية، والقاضية بتحويل مراكز الاهتمام من المدرس والمادة التعليمية إلى المتعلم، ومن بيداغوجيا التلقين والأهداف إلى بيداغوجيا التلقي والكفايات؛
- النقل الديدكتيكي السليم للمعارف والقيم والمهارات والكفايات المستهدفة إلى محتويات وأنشطة مُدَرّسة في وضعيات ديدكتيكية خاصة؛
- التحيين المتواصل لوسائل العمل الديدكتيكي الصفي وعدته، وفق مستجدات التربية والتكوين، وبناء على التطورات الحادثة في التفاعلات الصفية، وفي سيرورات التعلم وأوضاعه؛
إن كل هذه الأهداف والمرامي وغيرها لا تجد تحقيقها وتفعيلها إلا داخل نسق تعليمي متجدد ومتفاعل مع القضايا والإشكالات التي تفرزها المواد الدراسية، وعلى عاتق هذه العملية التدريسية توضع مهام التفكير في صيغ الإجابة النظرية والعملية عن أسئلة التدريس الجديد، وعن قلق المدرسين وتساؤلاتهم حول السبل المثلى لتيسير التعلم وتلبية حاجات المتعلمين، ومن ثمة لا تجد الديدكتيك اكتمالها ووضوحها إلا في اشتغالها على مادة تعليمية أو تخصص من التخصصات المدرسية وارتباطها بها، ولهذا ظلت الديدكتيك موضوع [مناقشة] مستمرة في مختلف المواد والتخصصات، [تتصل] بالإشكالات الخاصة بكل مادة تعليمية، وتتطور داخل الأبحاث المرتبطة بمكونات المادة و مناهج تدريسها[7].
إن هذا النسق الديدكتيكي لا يمكن تصوره مغلقاً أو معزولا عن نسق أشمل يندرج ضمنه، ونقصد به؛ التربية على القيم الذي يتشكل عبر المعارف التربوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، ويتفاعل معها التأثير والتأثر، وتمنحه وضعه الاعتباري المؤسسي. فإلى أي حد يتم استحضار مفهوم القيم داخل النقل الديدكتيكي؟
2.2- علاقة الديدكتيك بالقيم
تشكل التربية على القيم مكوناً مُهَيكلًا لبنية وظائف المدرسة، ولا سيما وظيفتها المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتربية والتثقيف، عن طريق الممارسة والقدوة؛ ذلك أن المدرسة فاعلٌ اجتماعي وثقافي وقيمي، وإحدى آليات الإدماج الاجتماعي والثقافي للمتعلمين والمتعلمات، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق تماسك المجتمع إلى جانب كونها وظيفة أفقية للمنظومة التربوية لا يمكن عزلها عن باقي الوظائف المناطة بها. كما أنها أحد أركان المنهاج المدرسي الهادف؛ من ثَمة فالارتقاء بالتربية على القيم يُعد من المهام والمسؤوليات الأساسية للمنظومة التربوية، مما يجعلها مدعوة على الدوام إلى تعبئة قدراتها وطاقاتها البشرية ومواردها المعرفية والمادية كافة، حتى تجعل من القيم واقعاً ملموساً، يجسده الاقتناع والالتزام والممارسة لدى المتعلمين)ات( والفاعلين)ات( التربويين)ات( بمختلف أصنافهم[8].
انطلاقاً مما سبق،» تشكل القيم مبادئ ومعايير متقاسمة لتوجيه المفاهيم والتمثلات والأحكام والسلوكات والمواقف والاتجاهات والمسوغات التي يتم إضفاؤها على الفكر والممارسة والسلوك. وتشغل موقع المرجعيات المؤطِّرة والموجِّهة لغايات العيش المشترك. كما ترتبط بسيرورة الواقع البشري وبدينامية المجتمعات وتحولاتها»[9].
وارتباطا بالسياق العام للمنظومة التربوية الحالية يتم تغييب مفهوم القيم أثناء العملية الديداكتيكية والاكتفاء بالدروس المجردة التي تفتقد المنهجية والبناء المحكم؛ الشيء الذي يكرس ثقافة الخمول والسلبية لدى البعض، كما يكرس علاقة تنافر بين المعرفة والقيم يسهم في توطيدها وضعيات سوسيو ثقافية واقتصادية وإعلامية. لذلك فالأمل معقود على كل الفاعلين التربويين بضرورة استحضار القيم أثناء تمرير التعلمات، لأن من واجب المدرسة توجيه المتعلم نحو ) وضعيات – مشكلة( تعترضه في الحياة، ولن يتفوق في مواجهتها إلا من خلال تشبعه بمختلف الثوابت المعرفية والأخلاقية، وتفاعله مع قيم المواطنة والهوية المتعلقة بالفرد والجماعة والحضارة والتاريخ. كما يتعين على الجميع جعل التربية على القيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة وفضائل السلوك المدني، والنهوض بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمييز، خياراً استراتيجياً لا محيد عنه، يتم تصريفه بناءً على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم من خلال المستويات الأربعة التالية:
- مستوى النهج التربوي؛
- مستوى البنيات التربوية والآليات المؤسساتية؛
- مستوى الفاعلين التربويين؛
- مستوى علاقة المؤسسة التربوية بالمحيط.
المراجع بالعربية:
المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “التريبة على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، (تقرير 1 / 17 )، يناير 2017.
المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030).
المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مصوغة التكوين المستمر لفائدة أساتذة مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي (إعدادي وتأهيلي)،إعداد الفريق المركزي للتكوين المستمر مادة اللغة العربية، أكتوبر 2009.
موسى حريزي، مجلة دراسات نفسية و تربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، عدد5، دجنبر 2010، جامعة البليدة، الجزائر.
المراجع غير العربية:
Antonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata, PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, España2009,
Said Tasra, pédagogie, didactique générale et didactique disciplinaire, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01531812 Submitted on 2 Jun 2017.
الإحالات:
[1]ـــ يرجع على سبيل المثال إلى الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، والميثاق الوطني للتربية والتكوين ( 1999)، ودليل الحياة المدرسية (2008 )، والتريبة على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، (يناير 2017).
[2]ـــ موسى حريزي، مجلة دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عدد5، دجنبر 2010، جامعة البليدة، الجزائر، ص:42.
[3]ـــ المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مصوغة التكوين المستمر لفائدة أساتذة مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي (إعدادي وتأهيلي)، إعداد الفريق المركزي للتكوين المستمر مادة اللغة العربية، أكتوبر 2009، ص: 10.
[4] ـAntonio Medina Rivilla y Francisco Salvador Mata, PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, España, 2009, p : 05.
[5] Said Tasra, pédagogie, didactique générale et didactique disciplinaire, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01531812 Submitted on 2 Jun 2017, p :13-16.
[6]– Said Tasra, pédagogie, didactique générale et didactique disciplinaire ,op cit, p3 :0.
[7]ــ مصوغة التكوين المستمر لفائدة أساتذة مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي (إعدادي وتأهيلي)، مرجع مذكور، ص: 7- 8.
«إن السؤال المركزي الذي يؤطر كل علاقة ديداكتيكية هو سؤال المعرفة في إطار أنساق تربوية عامة، وغير هذا السؤال لا يمكن أن يكون هناك ديداكتيك».
Said Tasra, pédagogie, didactique générale et didactique disciplinaire ,op cit, p03 :.
[8]ــ المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “التريبة على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، يناير 2017، ص: 05.
[9]ــ نفسه، ص: 04.
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم