بين تكوين النص وتمكينه يقف العالم كله بين مفترق طرق، وينقسم في مذاهبه المعرفية ومن ثم إدراكه للوجود وتكوين نظرياته لفهم الكون والوعي بنفسه ومصيره واتخاذ سبل النجاة نحو حياة أفضل (ن والقلم وما يسطرون) أقسم الله- سبحانه- بما نسطره، وما نسطره سيكون في النهاية نصا مركزيا في فهم الكون والوجود
والفرق الجوهري والعميق بين المسلمين وغيرهم هو مفهوم العلم أي ماذا يمكن أن يسمى علما، وهم يسمونه بالحقائق والمسلمات، العلم هو النص الذي يجب أن نؤمن به ونتحرك من خلاله، ويشكل مرجعيتنا ومصادرنا ويكون منطقياتنا ومبادئنا وأسس علاقتنا بهذا الكون.
المسلمون قد نزل عليهم النص أي العلم الحق، ووظيفة المسلمين الحقيقية هي العلم بما في هذا النص والمعرفة به وتعقله وفهمه والوعي به ، وغير ذلك مما جاء من أفعال الوعي في القرآن، ومن ثم يعظم لديهم التذكر والحفظ لأنه أداتهم لبقاء النص معهم حيثما كانوا؛ لأن النص يمثل لهم كل شيء ، منه يتعلمون، ومنه يعرفون، ومنه يعقلون ومنه ….إلخ به يحيون، وبه يفلحون وبه …إلخ، فنحن لا نسعى لتكوين النص كما يسعى إليه غيرنا بل نسعى لتدبره وبقدر تدبره وقراءته وتلاوته وترتيله بقدر ما نحيى حياة طيبة، وبقدر ما نفلح ونفوز ليس فقط في الدينا بل في الدنيا والآخرة
أما غير المسلمين فإنهم يسعون إلى تكوين هذا النص، فهم يبدؤون من الفراغ ويجتهدون في ملء هذا الفراغ، ومن ثم فكل ما لديهم من المسطور مشكوك فيه، وهو تحت الدراسة حتى يثبت بالتجربة وغيرها من أدوات الحس المباشرة، فهم في صراع دائم بين الأجيال وما ورثوه من أجل تكوين النص، حتى يمكن أن يكون علما ويشكل الحقيقة
فالمسلمون قد أوتوا النص الذي يمثل مرجعيتهم لفهم الكون والوجود، وغيرهم يسعون لتكوين هذا النص الذي يمكن من خلاله فهم الكون والوجود، وقد أدى هذا الفرق الجوهري إلى اختلاف نظريات المعرفة التي تنشأ من هذين الاتجاهين اختلافا لا يمكن معه أن يكون ثمة وفاق أو اتفاق لا في الغايات والمقاصد ولا في الأدوات والمنهجيات.
دعني أضرب مثلا للتوضيح:
نموذج بلوم يتحدث عن المعرفة وليس عن العلم؛ لأنه يرى أن المعرفة ما نراه وما نحسه وما نعرفه نحن، وليس ما يأتينا من العلم أي النص، فمرجعيته العلمية هي ما اكتشفه بأدواته هو. أما المسلم فمرجعيته العلمية هي ما أتاه من النص الثابت قرآنا أو سنة أي من الوحيين المباركين، ولذلك يجب أن يكون نموذج المسلم يبدأ بالعلم ثم المعرفة.
نموذج بلوم يجعل التذكر والفهم أدنى مستويات المعرفة؛ لأن النص لا يعنيه ولا يمكن الإيمان اليقيني به ويجعل التقويم أعلى مستوى للتعامل مع النص، أما النموذج الإسلامي فإنه لا يجعل التذكر أساسا ضمن المعرفة وإنما يجعله ضمن العلم ويجعل أعلى مستويات العلماء الحفظة ولذلك كان من أعلى درجات العلماء ما يسمى بالحافظ مثل الحافظ ابن كثير وغيره.
لذلك فإن العلاقة بين النموذج الإسلامي وغيره ترقى إلى مستوى المعركة أو الحرب بين اتجاهين متضادين ، وميدانها الأول هو النظرة إلى الوجود ومادة ذلك ومنشأ الجدل فيه هو مفهوم العلم والمعرفة وحَدّهما، فلما كان لليونانيين نظرتهم وفلسفتهم الخاصة عن الوجود استلزم ذلك أن يجعلوا لهم نظرية خاصة في المعرفة، فالعلاقة بين فهم الوجود والنموذج المعرفي علاقة توليدية، كل منها يلد الآخر أو ينتجه، وهذا ما وعاه علماؤنا عبر الأجيال خلال فترات تاريخنا الزاهر فكان لهم مناهجهم الفكرية ونماذجهم المعرفية الخاصة بداية من بناء الأطر والنهج حتى الانتهاء إلى النماذج و الأدوات والمقاييس، ومن ثم لم يدخلوا عمدا أو جهلا أو غفلة داخل إطار فكري آخر، فمنذ اللحظة الأولى والمخلصون يحاربون المنطق الأرسطي وما ينتهجه من النماذج المعرفية والأدوات الفكرية، ولم ينظروا إليها إلا بمنطق قوله تعالى [ولتستبين سبيل المجرمين] فهي علاقة استبانة وليس اتباع، وما وقعنا فيما وقعنا فيه من ذهاب نموذجنا والذوبان في الآخر إلا من خلال مجموعة قواعد تحتاج إلى الضبط وإعادة بناء منطقها الصحيح من أهمها(الحكمة ضالة المؤمن).
القاعدة الأولى الحكمة ضالة المؤمن:
مصدرية القاعدة: الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو قوله: (الكلِمةُ الحِكمةُ ضالَّةُ المؤمِنِ فحيثُ وجدَها فَهوَ أحقُّ بِها)، فقد أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وقال الترمذي في حكمه عليه: “حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المَدني المخزومي يُضعّف في الحديث من قِبلِ حفظه”.
مما سبق يتضح أن الحديث الذي تقوم عليه تلك القاعدة ليس بالصحيح، وعند افتراض أن الحديث صحيح فإنه يتعين علينا تعريف الحكمة والوقوف على حدها، ولن أخوض في ذلك فلسفيا بل إنني أقول بكل اختصار إن كلمة الحكمة جاءت في كتاب الله في حال تعليم الرسول لها مقرونة بالكتاب في قوله تعالى:{ هُوَ ٱلَّذِی بَعَثَ فِی ٱلۡأُمِّیِّـۧنَ رَسُولࣰا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِهِۦ وَیُزَكِّیهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبۡلُ لَفِی ضَلَـٰلࣲ مُّبِینࣲ }[سُورَةُ الجُمُعَةِ: ٢]
{ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ إِذۡ بَعَثَ فِیهِمۡ رَسُولࣰا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِهِۦ وَیُزَكِّیهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبۡلُ لَفِی ضَلَـٰلࣲ مُّبِینٍ }[سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٦٤]
{ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِیهِمۡ رَسُولࣰا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَیُزَكِّیهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ }[سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٢٩]
وعند النظر في تلك الآيات نجد أن الله جعل الكتاب والحكمة عاملين لمفعول واحد وهو يعلمهم، ولم يفصل بينهما فيقول (ويعلمهم الكتاب الحكمة) وهذا الجمع بين الكتاب والحكمة تحت فعل واحد إنما يشير دلالة واضحة أن الحكمة مقرونة بالكتاب ومقرونة بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يعقل أن تكون هناك حكمة لم يعلمها الرسول، ولم تذكر في كتاب الله، وعليه فإن الفهم الصحيح لتلك القاعدة إذا اعتبرت قاعدة هو:
الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها في كتاب الله أو سنة رسوله فهو أحق الناس بها، بل يمكن القول بأن الحكمة -بالمفهوم السائد لهذه القاعدة – ليست ضالة المؤمن.
والمجال واسع والأمثلة وفيرة على نماذج ومنطقيات ليست بنت تراثنا اعتبرناها حكمة، ثم تبين أنها لم تكن كذلك، وإن شاء الله سأفرد لذلك مقالات تتعلق بمدى الاختلافات الفكرية في بعض النماذج التي نعتبرها حكمة مثل نموذج بلوم (هرم بلوم) أو نموذج ماسلو للاحتياجات.
إن القاعدة الأصيلة هي أن المؤمن يرتاب من كل شي لم يأت في كتاب الله أو سنة رسوله حتى يثبت صحته وسلامته، والأصل في المعارف ونماذجها أنها تحت الاستبانة ما لم تثبت صحتها طالما أنها ليست مستنبطة من الكتاب والسنة ابتداء وليست استدعاء، كما يفعل البعض يأتي بالقاعدة أو النموذج ثم يذهب ليجد له شيئا من النص يستدعيه ليقدم به نموذجه، فأصبحت نصوص الإسلام مقدمات ومؤخرات وليست للعلم والمعرفة مكونات.
القاعدة الثانية:
البحث عن بدائل لما في النماذج الغربية من -مفاهيم وليس بناء نماذج أصيلة من تراثنا.
وهذه القاعدة تأتي مباشرة بعد أن نتفق أن الحكمة ضالة المؤمن يجب أن يبحث عنها في كتاب الله وسنة رسوله، فيقول المخلصون في أنفسهم وما البديل عن كذا يريدون البحث عن بديل عنها في كتاب الله أو سنة رسوله، وهذه قد لا تكون قاعدة بقدر ما هي منطق يوجه التفكير عندما نواجه مفهوما غربيا ليس في البنية المعرفية الإسلامية الأصيلة ومثال ذلك:
ما بديل كلمة قيمة التي تستخدم الآن فيقولون قيمة الصدق، أو الأمانة، أو قيمة الشفافية أو المرونة أو غير ذلك؟ ويمكن القول: إن أي كلمة تمثل مفهوما ترتبط به منظومة مفاهيمية كاملة، فكلمة القيم بالمعنى الذي يستخدم الآن في مجال الأخلاق والتزكية هي مفهوم ضمن منظومة كاملة من ذلك: غرس القيم، وبناء القيم، ومراحل القيم، والنسق القيمي والدافع القيمي، والتوجه أو الاتجاه القيمي، ومصفوفة القيم وأدواتها …إلخ وعليه فإنه لا يمكن استبدال كلمة بكلمة فلا يقال إذا كنت تقول إن كلمة القيم لم تستخدم في البنية المعرفية الإسلامية بهذا المفهوم من قبل، وتم تمعين اللفظ بمعاني ليست أصيلة فيه وانما تم استعمار اللفظ – الاستعمار المفاهيمي- بمعاني لا يحتملها اللسان العربي لتلك المفردة فما بديل تلك الكلمة، ماذا نقول إذا لا تريدنا أن نقول كلمة القيم؟
أقول إن الكلمة لا تستبدل بكلمة إذ إن الكلمة كما ذكرت تمثل منظومة مفاهيمية مع باقي الكلمات التي تستحضر معها، وعليه فإننا نبني منظوماتنا المفاهيمية الخاصة بنا فنسأل ما المنظومة الإسلامية التي تمثل أصلا يبني ما نريده من كذا ونبدأ في بناء منظوماتنا أو اكتشافها داخل تراثنا
القاعدة الثالثة: -الأصل في المعاملات او الأشياء الإباحة.
القاعدة الرابعة: -أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
ولعظم أمر هذين الأصلين سأجتهد إن شاء الله في إعادة تعريفهما في مقال آخر
إن ميدان التدافع الأول بين الحق والباطل هو ميدان المعرفة وما يستلزم ذلك من أطر ونماذج وأدوات تؤطر المعرفة وتنتجها، وإن أي متقدم لعملية تطوير تربوي أو تعليمي من أجل هذا الوطن المبارك ومن أجل أمتنا لم يع ذلك ويضبط التوجه نحوه ويقود الجهود تجاهه فهو يجاهد في غير ميدان المعركة الحقيقي، وهو كمن يبحث مفقوده في غير مكان الفقد، ليس لشيء إلا لأن الشقة بعدت عليه فاتبع عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لكن هيهات هيهات أن يظفر بما يدافع من أجله
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
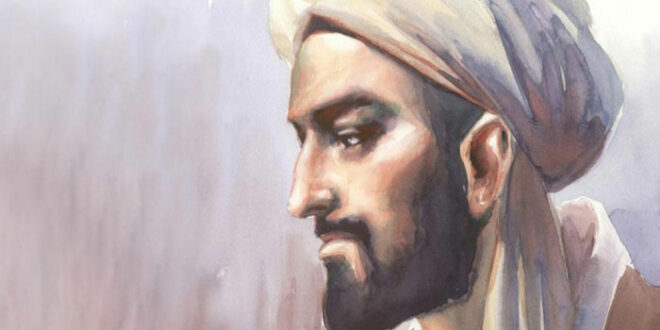


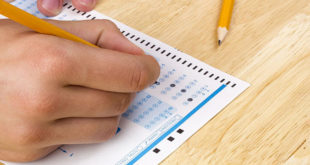




تنبيه مهم جدا جدا جدا
جاء في المقال مانصه:
” أما المسلم مرجعيته العلمية هي ما آتاه من النص الثابت قرآنا”
والذي اقصده ككاتب للمقال
” أما المسلم مرجعيته العلمية هي ما آتاه من النص الثابت قرآنا وسنة أي من الوحيين المباركين
ما أتاه وليس ما آتاه