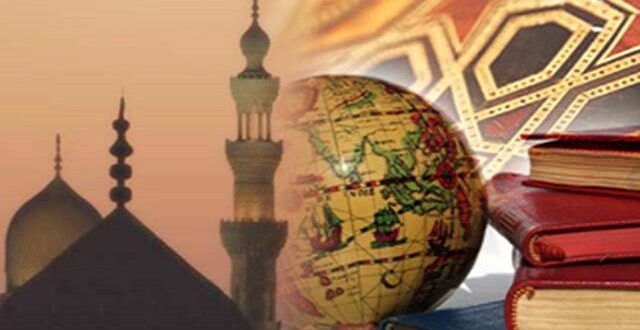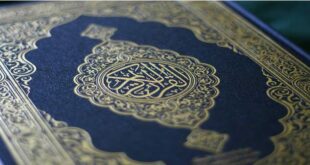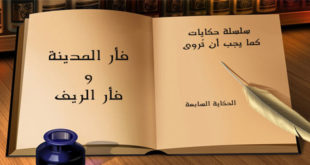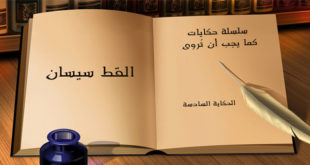مدخل
يمثل القصص القرآني نموذجا إرشاديا في المواقف الحياتية المختلفة التي يواجهها الناس، والاعتبار بالقصص القرآني يهدي لاتخاذ القرارات الصحيحة المعززة للإيجابية، وقد تضمن القرآن الكريم العديد من قصص الأنبياء والمرسلين، ومنها قصة يوسف عليه السلام، والتي وردت في سورة كاملة تضمنت 111 آية، وقد ورد في مطلع سورة يوسف أنّ الله سبحانه وتعالى سيقص علينا أحسن القصص، قال الله عزّ وجلّ: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِين}[يوسف:3].
وتفيد الآية الأخيرة من السورة بأنّ هذا القصص فيه عبرة لأولي الألباب، قال الله عزّ وجلّ: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون}[يوسف:111].
وقد تضمنت قصة يوسف عليه السلام ملامح من أطواره العمرية، وأساليب الرعاية التي قدمت له، والتحديات والصعوبات التي واجهته في تلك الأطوار، في طفولته وشبابه وكهولته. وسوف نسعى في هذا المقال لاستنباط بعض المبادئ التي يمكن الاعتبار بها لرعاية الطفولة من خلال طفولة يوسف عليه السلام.
يتضح من سورة يوسف أنّ ما يتعلق بأطوار طفولة يوسف عليه السلام قد وردت في الآيات الأولى من السورة، أي ما قبل الآية رقم 22، لأنّ الآية رقم 22 ورد فيها بلوغه طور الأشد، قال الله عزّ وجلّ: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين}[يوسف:22].
وطور الأشد هو الطور التالي لطور الطفولة، قال الله عزّ وجلّ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون}[غافر:67]، وقال الله عزّ وجلّ: {… ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ…}[الحج: 5].
وقد ورد في تلك الآيات السابقة للآية 22 من السورة، وصف يوسف عليه السلام بأنّه غلام، وذلك بعد أن ألقاه إخوته في البئر، قال الله عزّ وجلّ: {وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـذَا غُلاَمٌ …}[يوسف:19]. وكلمة الغلام تشير إلى نهايات أطوار الطفولة، ومما يدل على ذلك أنّ الآيات القرآنية تشير إلى أنّ الغلام هو من لم يبلغ السعي ولم يبلغ الأشد من الذكور، قال الله عزّ وجلّ: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ..}[الكهف:82]. وقال الله عزّ وجلّ: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيم (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ..} [الصافات: 101 -102].
وبذا فإنّ الآيات الأولى من سورة يوسف (من1 إلى 21)، هي الآيات التي تضمنت ما يتعلق بطور الطفولة ليوسف عليه السلام، ولما كانت حياة الأنبياء والرسل هي نماذج هادية، فإنّه من الضروري الاستفادة منها في الجوانب الحياتية المختلفة، وباستقراء تلك الآيات الأولى من سورة يوسف، وعن طريق تدبرها والتفكر فيها يمكن استنباط المبادئ التالية لرعاية الأطفال.
أولا: مبدأ الاتصال الوالدي الفعال
يتضح من قصة يوسف أنّ والده كان متواصلا معه تواصلا فعالا وإيجابيا، لدرجة أنّ يوسف كان يحكي لوالده التفاصيل المتعلقة بالأحلام والرؤى التي يراها في منامه، وهذا يدل على أنّ والد يوسف كان يستمع بصورة جيدة لابنه الطفل، وتبين القصة أنّ الطفل يوسف قد رأى في منامه رؤيا، وقصّ تلك الرؤيا على والده، وأنّ والده قد عبّر له تلك الرؤيا، وقدم له الإرشادات المرتبطة بتلك الرؤيا.
قال الله عزّ وجلّ في سورة يوسف: {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَاأَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين (4) قَالَ يَابُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِين (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم (6)}.
ويُستنبط من هذا المبدأ أهمية وضرورة التواصل الفعال بين الوالدين وأطفالهم، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من التضحية، وإعطاء وقت كاف للطفل، وزيادة الساعات التي يقضيها الوالدان مع أطفالهما، وضرورة مشاركة الوالدين أطفالهم في تفاصيل اهتماماتهم، وإشعارهم بالأمان الذي يجعلهم يعبرون لوالديهم عن كل ما يواجههم، أو ما يودون استكشافه والتساؤل عنه، وخاصة في هذا العصر الذي أصبحت الميديا تنقل للطفل مواد كثيرة جدا.
ثانيا: توفير الأمن والسلامة
تتطلب رعاية الأطفال توفر الأمن والسلامة الشاملة، والحاجة للأمن هي إحدى الحاجات الأساسية في هرم الحاجات الإنسانية، والأطفال هم أشد حاجة للأمن نظرا لضعفهم التطوري، لأنّهم مازالوا في مرحلة البناء الجسمي والعقلي، ولذا نجد الأطفال يعتمدون على والديهم والكبار الآخرين في توفير الأمن والسلامة لهم. وتفيد قصة يوسف عليه السلام أنّه قد نشأ نشأة آمنة، وفرها له أبوه برعايته الشاملة، ولذلك لما علم إخوة يوسف باهتمام أبيهم وحرصه على توفير الأمن والسلامة ليوسف، ضمنوا لوالدهم أنّهم سيوفرون ليوسف الأمن والسلامة المطلوبة، ليسمح لهم بأخذه معهم بعيدا عنه. قال الله عزّ وجلّ على لسانهم: {قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُون}[يوسف:11].
ويبدو أنّهم قد أكثروا من الطلب عدة مرات، ولكن أباهم لم يقبل طلبهم ورفضه، لتقديره بعدم كفاية الأمن اللازم لرعاية هذا الطفل من قبل إخوته. وقد انتبه بعض المفسرين إلى هذا الأمر! فقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: “وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُخْرِجَ مَعَهُمْ يُوسُفَ فَأَبَى” (القرطبي). وقال ابن عاشور: “ولَعَلَّ يَعْقُوبَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – كانَ لا يَأْذَنُ لِيُوسُفَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – بِالخُرُوجِ مَعَ إخْوَتِهِ لِلرَّعْيِ أوْ لِلسَّبْقِ خَوْفًا عَلَيْهِ مِن أنْ يُصِيبَهُ سُوءٌ مِن كَيْدِهِمْ أوْ مِن غَيْرِهِمْ، ولَمْ يَكُنْ يُصَرِّحُ لَهم بِأنَّهُ لا يَأْمَنُهم عَلَيْهِ ولَكِنَّ حالَهُ في مَنعِهِ مِنَ الخُرُوجِ كَحالِ مَن لا يَأْمَنُهم عَلَيْهِ فَنَزَّلُوهُ مَنزِلَةَ مَن لا يَأْمَنُهم، وأتَوْا بِالِاسْتِفْهامِ المُسْتَعْمَلِ في الإنْكارِ عَلى نَفْيِ الِائْتِمانِ” (ابن عاشور).
وبهذا يتضح أنّ حاجة الطفل للأمن حاجة كبيرة وضرورية، ولابد من مراعاتها في رعاية الطفولة، وكلمة الأمن تعبر عن مفهوم شامل متعدد الأوجه، ولذا فمن الضروري توفير الأمن بأوجهه المختلفة للأطفال ولكن أهمها الأمن النفسي.
ويتمثل الأمن النفسي في توفير أعلى معايير ومستويات الصحة النفسية وجودة الحياة للطفل، ومما يؤكد ذلك أنّ كلمة الأمن في القرآن قد وردت منافية للخوف؛ قال الله عزّ وجلّ في قصة موسى عليه السلام: {.. يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِين} [القصص:31]. والأمن لا يكون معه فزع، قال الله عزّ وجلّ: {.. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُون} [النمل:89]. والأمن تكون معه الطمأنينة وإشباع الحاجات الأساسية، قال الله عزّ وجلّ: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُون} [النحل:112]. والأمن تكون معه السكينة والاستقرار في المأوى، قال الله عزّ وجلّ: {.. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُون} [سبأ:37].
ثالثا: الإرشاد الوقائي للأطفال وتعديل سلوكهم وتصويب أخطائهم برفق (النصيحة)
يتضح من قصة يوسف عليه السلام أنّ أباه كان يوفر له الإرشاد الوقائي وكان يُعنى بتصويب أخطائه وتعديل سلوكه برفق، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال العرض الذي قدمه إخوة يوسف لأبيهم ليسمح لهم بأن يأخذوه معهم، وضمنوا له أنّهم سيكونوا له ناصحين، وذلك في قوله عزّ وجلّ: {قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُون} [يوسف:11].
وكلمة النصح في اللغة تدل عَلَى مُلَاءَمَةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَإِصْلَاحٍ لَهُمَا (مثل خياطة الثوب). والنُّصْحُ وَالنَّصِيحَةُ: خِلَافُ الْغِشِّ. والناصح هو الذي يوصف بِخُلُوصِ الْعَمَلِ (ابن فارس، ص993). والنُّصْحُ: تَحَرِّي فِعْلٍ أو قَوْلٍ فيه صلاحُ صاحبِهِ (الأصفهاني، ص808).
والنصيحة بهذا المفهوم تدل على الإرشاد الوقائي البنائي الإصلاحي المتسم بالإخلاص والعلم بما يفيد المنصوح، وتدل على الأمانة والإحكام في الأداء، وتدل على الإيجابية من خلال رتق وخياطة وتعديل الاختلال السلوكي بمهارة عالية، وبإخلاص كبير، وإرادة للخير. وقد وردت كلمة النصيحة فيما يتعلق بالطفولة في قصة موسى عليه السلام أيضا، عندما كان رضيعا، وذلك في قول الله عزّ وجلّ: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُون} [القصص:12].
وبناء على ذلك فإنّه من المبادئ الضرورية في رعاية الأطفال رعاية إيجابية، أن يقوم من حولهم بنصحهم منذ طفولتهم المبكرة، ويتمثل مفهوم النصح من الناحية الإجرائية في متابعة الأطفال متابعة دقيقة، ومراقبتهم، والحرص على تصويب أخطائهم وتعديل سلوكهم برفق.
وبهذه المناسبة لابد من توجيه الآباء والمحيطين بالطفل بضرورة التمييز بين الخطأ السلوكي الموقفي، وبين الذات بالنسبة للأطفال، بمعنى أنّ الطفل إذا أخطأ علينا ألا نقول له أنت المقصر، أو أنت الذي لا تعرف، أو أنت كذا وكذا، من الألفاظ السلبية التي يقولها المحيطون بالأطفال ولا يلقون لها بالا! والتي تجعله ينظر لذاته بمنظار سلبي. ولكن علينا أن نخاطب سلوكه، وأن نوجهه برفق: يا بني ما قمت به هو سلوك خطأ. والصواب كذا وكذا، وبذا نكون قد فرقنا بين السلوك الخطأ والذات بالنسبة للطفل، لأنّ هذه المسألة ستؤثر في نمو ذاته، وتقدير ذاته، وبناء شخصيته في المستقبل.
ومن المعلوم أنّ الأطفال في أطوار نموهم الأولى يسعون لتأكيد ذواتهم بالقيام بالأعمال التي يقوم بها الكبار، وتقليد الكبار ومحاكاتهم، فيحملون الأواني مثلا، ولكنهم لا يستطيعوا التحكم فيها، بحكم ضعف بنيتهم الجسمية، فتسقط منهم تلك الأواني وتتكسر، وبالتالي يقوم المحيطون بهم بزجرهم وتوبيخهم، وعقابهم في بعض الأحيان، ووصمهم بأنّهم كذا وكذا، وهذا يخالف مفهوم النصح الذي ورد في قصة يوسف وفق المفهوم القرآني.
رابعا: توفير المتطلبات الغذائية للأطفال (الرتع)
ورد في قصة يوسف أنّ إخوته قد ضمنوا لأبيهم أنّهم سيوفروا ليوسف (الرتع) ليسمح لهم بأخذ يوسف معهم. وقد ورد ذلك في قول الله عزّ وجلّ: {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون} [يوسف:12].
والرتع: السعة في المأكل والمشرب (ميقاتي وآخرون، 362). رتَعَ يَرْتَعُ، إِذَا أَكَلَ مَا شَاءَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْخِصْبِ (ابن فارس، 420). ومن المنظور النفسي تشير كلمة الرتع إلى السلوك المرتبط بإشباع الحاجات الغذائية والاستمتاع بها في الطفولة، وتشير إلى عملية رعاية الأطفال بما يحقق لهم إشباعا لحاجاتهم الغذائية في يسر وأمان وسرور (سليمان، 2023).
وهذا المبدأ يبين أهمية توفير المتطلبات الغذائية التي يحتاجها الطفل بما يؤدي إلى إشباع حاجاته، وتحقيق متطلباته النمائية.
خامسا: اللعب
تضمنت قصة يوسف أنّ والده قد سمح لإخوته أن يأخذوه معهم عندما ضمنوا له أنّهم يريدونه أن يلعب، وأكدوا التزامهم بحفظه، قال الله عزّ وجلّ: {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون} [يوسف:12].
واللعب في الطفولة هو حاجة نمائية، تظهر وتتمثل في الأنشطة الحركية والتواصلية التي يقوم بها الطفل، بصورة تلقائية، ويشعر من خلالها بالراحة والمتعة والسرور، لأنّ تلك الأنشطة والممارسات السلوكية تشبع الحاجة النفسية للعب لدى الطفل. ولذا من الضروري جدا مراعاة توظيف اللعب في تربية الأطفال وتنشئتهم.
واللعب ليس مجرد وسيلة للمتعة فقط للأطفال، بل هو الأساس الذي يستند عليه الطفل في النمو، في جوانب شخصيته المختلفة. واللعب يمثل طريقة سلسة للتعلّم وبناء المهارات الحياتية الهامة، ومنها تعلّم حلّ المشكلات والتعبير عن الأفكار، بالإضافة إلى تطوير وتنمية الذكاء العاطفي، والتواصل مع الآخرين، وبناء العلاقات الاجتماعية.
ويمكن للطفل أن يحسن قدراته الحسية والحركية وفهم محيطه من خلال تكديس الأشياء، وبالتالي تعزيز صحة الجسم ونشاطه. ومن خلال قيام الطفل ببعض الممارسات مثل إخفاء الأغراض المنزلية والبحث عنها، وذلك من أجل أن يطور مهاراته في التركيز وحلّ المشكلات ومهارات التفكير.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الأطفال ويلاعبهم ويسألهم عن ألعابهم، كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: (كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يدخل علينا ولي أخ صغير يُكنى أبا عُمير، وكان له نغر يلعب به، فمات فدخل عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم فرآه حزينًا، فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟) (صحيح البخاري، حديث رقم 6203).
سادسا: الغمر العاطفي (التعلق والحنان)
هناك العديد من المصطلحات والمفاهيم في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية التي تدور حول العلاقة العاطفية بين الآباء والأبناء، والتي تستند على حاجة الأطفال للغمر العاطفي والحنان وتدعيم التعلق بالوالدين، ومن جانب آخر تُعنى تلك المصطلحات بالأساليب الإيجابية التي يقوم بها الآباء تجاه الأبناء لتحقيق وإشباع تلك الحاجات العاطفية.
وتشير الدراسات النفسية والتربوية والاجتماعية بصورة عامة إلى أنّ الأساليب الإيجابية التي يستخدمها الآباء مع أبنائهم في الطفولة، وأنّ الاتجاهات الوالدية الإيجابية من الآباء نحو الأبناء في الطفولة تؤثر كثيرا في جوانب نمو شخصياتهم بصورة إيجابية، ويتضح ذلك من خلال نمو الثقة في النفس، ونمو مفهوم الذات وتقدير الذات، وتعزيز الصحة النفسية، وظهور أنماط الشخصية الإيجابية، ونمو المقدرة على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الآخرين، والمقدرة على التعلم وتحقيق معدلات مرتفعة في التحصيل الدراسي، والمقدرة على حل المشكلات، وتعزيز الابتكارية والإبداعية.
ويتضح من قصة يوسف عليه السلام أنّه قد تنعم بالغمر العاطفي من والده، فقد كان يحبه حبا شديدا، حتى ظنّ إخوته – خطأ منهم – أنّهم لا ينالون مثل ذلك الحب، ولذلك سعوا لإبعاده هو وأخاه من وجه أبيهم؛ قال الله عزّ وجلّ في سورة يوسف: {لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِين (7) إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِين (8)}. والشاهد في هذه الآية أنّ يوسف قد كان مغمورا بمحبة والده له. وقال الزمخشري في تفسيره: “(لَيُوسُفُ) اللام للابتداء. وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة. أي: أرادوا أنّ زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه”(الزمخشري).
ومما يدل على الغمر العاطفي والارتباط الوجداني بين يوسف ووالده، أنّ أباه كان لا يكاد يستطيع فراقه، وأنّه يحزن لفراقه، وكان يخاف عليه خوفا شديدا إذا فارقه أو غاب عنه، وكان لا يغفل عنه عندما يكون معه، ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد في قول الله عزّ وجلّ: {قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُون}[يوسف:13].
وهناك العديد من الشواهد في القرآن الكريم والسنة النبوية تؤكد أهمية الغمر العاطفي وضرورة الحنان والشفقة والتعلق الإيجابي بين الأطفال ووالديهم. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عن أم موسى وطفلها، وما ورد عن مريم وعيسى، وزكريا ويحيى، وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام جميعا.
والسيرة النبوية فيها كثير من المواقف في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال. فقد ورد في الحديث: “قَبَّلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ وعِنْدَهُ الأقْرَعُ بنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأقْرَعُ: إنَّ لي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ ما قَبَّلْتُ منهمْ أحَدًا، فَنَظَرَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ” (البخاري، حديث رقم 5997 ).
سابعا: الحفظ والمراقبة
يوجد أطفالنا بيننا ولكنهم يعيشون في عوالم أخرى تتمثل في الوسائط التي تغرقهم بالمواد المختلفة، حتى أصبحوا غرباء في بيوتهم، ولكنهم يتفاعلون مع محتويات الأجهزة الذكية ومواد الانترنت، ولا يكادون ينفكون عنها، حتى وصلوا لمرحلة الإدمان الالكتروني، وشاهدوا كثيرا من المشاهد التي يفترض ألا يشاهدونها، واكتسبوا كثيرا من السلوكيات والعادات والاتجاهات والميول، بدون معرفة آبائهم وأمهاتهم.
وفي السابق كان الآباء المربون يهتمون بحفظ أطفالهم ومراقبتهم في المساحات المرئية، والفضاءات المحدودة التي ينشطون فيها، وهم يلعبون ويرتعون، على الرغم أنّه لا توجد مهددات خارجية كثيرة!! اللهم إلا بعض الهوام والحيوانات المؤذية، أو التنمر والعدوان من بعض الأقران.
وبالنظر لقصة يوسف نجد أنّ والده كان حافظا له، وغير غافل عنه، ومراقبا له، وخائفا عليه، لدرجة أنّ إخوته لما أرادوا أن يأخذوه معهم لم يسمح لهم إلا بعد تأكيدهم على قيامهم بحفظه، وعدم الغفلة عنه، ومراقبته، وتوفير السلامة والوقاية له. كما ورد في قول الله عزّ وجلّ في سورة يوسف: {قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُون (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُون (13) قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُون (14)}.
ويستفاد من هذا أنّ المحافظة على الأطفال، ومراقبتهم، وعدم الغفلة عنهم، يمثل درجة عالية من الأهمية في رعايتهم ونموهم، ويزداد هذا الأمر أهمية في هذا العصر الرقمي، الذي دخلت فيه ذئاب الوسائط إلى الأطفال في غرفهم المغلقة.
ويزداد الأمر صعوبة نظرا لانشغال الآباء والأمهات في الوظائف التي تأخذهم بعيدا عن أطفالهم مما يجعلهم بعيدين عن المراقبة والمحافظة.
ثامنا: توفير متطلبات السكن والبيئة المحيطة بالطفل بجودة عالية (إكرام المثوى)
يتطلب نمو الطفل أن يكون في بيئة ومأوى تتوفر فيه متطلبات جودة الحياة بمعايير عالية، ولذلك طلب عزيز مصر من امرأته أن تكرم مثواه، وذلك بتهيئة المأوى الذي تتوفر فيه معايير جودة الحياة بمستوى رفيع، كما ورد في قول الله عزّ وجلّ: {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون}[يوسف:21]. ومما يدل على أنّ يوسف قد توفر له الإكرام في المثوى ما ورد على لسانه في حديثه عن عزيز مصر: {..إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ..}[يوسف:23].
و(إكرام المثوى) عبارة جامعة لكل متطلبات جودة المأوى والمسكن، وقد بيّن المفسرون هذه العبارة بمعاني تتضمن ذلك، قال الطبري: (أكرمي مثواه): أكرمي موضع مقامه، وذلك حيث يَثوِي ويُقيم فيه (الطبري). وقال الماوردي: وَإكْرامُ مَثْواهُ بِطَيِّبِ طَعامِهِ ولَيِّنِ لِباسِهِ وتَوْطِئَةِ مَبِيتِهِ (الماوردي). وقال الزمخشري: (أَكْرِمِي مَثْواهُ): اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماً، أي حسناً مرضياً، بدليل قوله: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ)، والمراد تفقديه بالإحسان وتعهديه بحسن الملكة، حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا، ساكنة في كنفنا. ويقال للرجل: كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل به من رجل أو امرأة، يراد: هل تطيب نفسك بثوائك عنده، وهل يراعى حق نزولك به (الزمخشري).
تاسعا: التبصير بالمخاطر: (يكيدوا لك كيدا،،، الشيطان عدو)
يحتاج الأطفال للحماية من المخاطر المتنوعة التي قد تسبب لهم الأذى في أي من الجوانب الجسمية، أو الحركية، أو العقلية، أو العاطفية. ولذا فإنّ رعايتهم تتطلب وقايتهم من المخاطر، وتبصيرهم بها، وتنمية وعيهم لكيفية وقاية أنفسهم منها، ولذا فقد أرشد يعقوب طفله يوسف وبصره بالمخاطر المتوقعة، ودله على التصرف الصحيح الذي ينغي أن يقوم به إزاء كيد إخوته وكيد الشيطان، كما ورد في قول الله عزّ وجلّ: {قَالَ يَابُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِين}[يوسف:5]. أيْ فَيَحْتالُوا لِإهْلاكِكَ حِيلَةً عَظِيمَةً لا تَقْدِرُ عَلى التَّفَصِّي عَنْها أوْ خُفْيَةً لا تَتَصَدّى لِمُدافَعَتِها (الألوسي). وقَوْلُ يَعْقُوبَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – هَذا لِابْنِهِ تَحْذِيرٌ لَهُ مَعَ ثِقَتِهِ بِأنَّ التَّحْذِيرَ لا يُثِيرُ في نَفْسِهِ كَراهَةً لِإخْوَتِهِ لِأنَّهُ وثِقَ مِنهُ بِكَمالِ العَقْلِ، وصَفاءِ السَّرِيرَةِ، ومَكارِمِ الخُلُقِ. ومَن كانَ حالُهُ هَكَذا كانَ سَمْحًا، عاذِرًا، مُعْرِضًا عَنِ الزَّلّاتِ، عالِمًا بِأثَرِ الصَّبْرِ في رِفْعَةِ الشَّأْنِ (ابن عاشور).
عاشرا: التعزيز الإيجابي وتنمية الفاعلية للطفل
يستفاد من قصة يوسف أنّ والده يعقوب كان على تواصل وتفاعل إيجابي معه بدرجة كبيرة جدا، وقد تضمن محتوى ذلك التواصل التركيز على الإيجابيات، وربطه بالقدوات من السابقين المعروفين في إطار الأسرة من آبائه الأنبياء السابقين؛ كما ورد في قول الله عزّ وجلّ: {وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم}[يوسف:6].
وهذا يؤكد أنّ هناك ضرورة للتعزيز الإيجابي وربط الطفل بالقدوات المميزين عبر القصص والرسائل التواصلية المباشرة.
الخلاصة والتوصيات
تبين من قصة يوسف عليه السلام أنّها تضمنت مبادئ أساسية لرعاية الأطفال، وهي أولا: مبدأ الاتصال الوالدي الفعال، ثانيا: توفير الأمن والسلامة، ثالثا: الإرشاد الوقائي للأطفال وتعديل سلوكهم وتصويب أخطائهم برفق (النصيحة)، رابعا: توفير المتطلبات الغذائية للأطفال (الرتع)، خامسا: اللعب، سادسا: الغمر العاطفي (التعلق والحنان)، سابعا: الحفظ والمراقبة، ثامنا: توفير متطلبات السكن والبيئة المحيطة بالطفل بجودة عالية (إكرام المثوى)، تاسعا: التبصير بالمخاطر: (يكيدوا لك كيدا،،، الشيطان عدو)، وعاشرا: التعزيز الإيجابي وتنمية الفاعلية للطفل. وبناء على هذه المبادئ نقدم هذه التوصيات:
- 1) على الآباء أن يكونوا في تواصل مع أطفالهم، وأن يدخلوا في تفاصيلهم، ويسمحوا لهم أن يسألوهم ويعبروا عما يشعرون به ويواجهونه، وأن يقدموا لهم الإرشادات المناسبة بناء على تواصلهم معهم، وذلك فيما يتعلق بصحوهم أو منامهم.
- 2) هناك مجموعة من التوجيهات الإجرائية التي تعزز الأمن النفسي للأطفال والتي ينبغي أن تتم مراعاتها؛ ومنها: تجنب تهديد الطفل، إكثار الوالدين من حضن الطفل، إبعاد المواد الضارة والأجهزة الخطيرة من المنطقة التي يتحرك فيها الطفل، وحماية الطفل من تنمر أقرانه أو الأطفال الأكبر منه.
- 3) ضرورة التحلي بالصبر في التعامل مع الأطفال عندما يخطؤون، وتصحيح أخطائهم وتصويبها برفق، وبصورة إيجابية بحيث يتم فيها التمييز بين ذات الطفل، وبين السلوك الخاطئ، وبالتالي يتم تعديل سلوكهم وبنائه وتدريبهم على اتقان المهارات بصورة فعالة.
- 4) أهمية توفير الغذاء المناسب للأطفال، وذلك من خلال توفير العناصر الغذائية اللازمة لدعم نمو الأعضاء والأنسجة وتطوير الوظائف العقلية بشكل سليم، ودعم الحاجة للطاقة والنشاط والحركة المستمرة التي يقوم بها الأطفال، وبناء العادات الغذائية الجيدة والصحية التي تستمر مع الأطفال طوال حياتهم. وذلك لأنّ الأطفال الذين يتبعون نظاما غذائيا مناسبا يكونوا أقل عرضة للإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية، وخاصة النمائية والتطورية.
- 5) التركيز عليها في موضوع اللعب في الطفولة وذلك لأنّ مطلب من مطالب النمو السوي للأطفال، ولأنّ اللعب يمثل العمود الفقري الذي يفترض أن تبنى عليه البرامج والأنشطة المختلفة. ومن الضروري التأكيد على تنويع أنشطة اللعب، وخاصة في هذا العصر الذي أضحى فيه الأطفال مرتبطين بالأجهزة الذكية وألعاب البلايستيشن بدرجة كبيرة جدا. ولذا لابد من مساعدة الأطفال وتوجيههم لأنشطة متنوعة أخرى مثل الرياضات الجسمية، والتعامل مع الطبيعة، والقيام بالسياحة، وزيارة المرافق والمصانع والأماكن المتنوعة. ومن الضروري مشاركة الآباء والإخوة الكبار للصغار في الألعاب المختلفة، كما رأينا في سماح يعقوب عليه السلام بإرسال يوسف مع إخوته الكبار ليلعب.
- 6) التأكيد على أهمية الغمر العاطفي والشفقة والحنان الذي يفترض أن يقدمه الوالدان لأطفالهما، حتى ينشؤوا نشأة طيبة، وحتى يشبعوا جانب التعلق العاطفي لدى الأطفال، لأنّ ذلك سيؤثر بصورة إيجابية في بناء شخصياتهم، وتنمية ثقتهم في أنفسهم، ويساعدهم على النمو بصورة إيجابية.
- 7) المتابعة والمراقبة للأطفال بصورة عامة سواء في المنزل أو الحدائق أو الحارات والشوارع، والقيام بإعداد أدوات الرقابة الأبوية الالكترونية على الأجهزة الذكية والتي تحمي الطفل من الدخول لجميع المواقع والتطبيقات الذكية، وخاصة غير المناسب للأطفال (إجراءات البحث الآمن).
- 8) توفير متطلبات السكن والبيئة المحيطة بالطفل بجودة عالية (إكرام المثوى).
- 9) تبصير الأطفال بالمخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجههم في حياتهم، حتى يستعدوا لها بالطرق المناسبة.
- 10) ضرورة القيام بالتعزيز الإيجابي وتنمية الذات والثقة بالنفس لدى الطفل من خلال ربطه بالقدوات الصالحين عن طريق القصص.
المصادر والمراجع:
- القرآن الكريم
- ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير “تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد”. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/ibn-aashoor/).
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد. معجم مقاييس اللغة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2001 م.
- الأصفهاني، الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، ط5، دمشق: دار القلم، 2011 م.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/alaloosi).
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، تطبيق الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، (https://dorar.net/hadith/sharh/12366).
- الزمخشري، محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/kashaf/).
- سليمان، السر أحمد. القاموس النفسي القرآني، الرياض: مكتبة العبيكان، (2023).
- الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/tabari/).
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/qurtubi/).
- الماوردي، أبو الحسن محمد بن حبيب. تفسير الماوردي: النكت والعيون. تطبيق الباحث القرآني: (https://tafsir.app/almawirdee/).
- ميقاتي، محمد باسم، معصراني، محمد زهري، والدندشي، عبد الله أحمد. القطوف من لغة القرآن. ط1، بيروت: مكتبة لبنان، 2007 م.
 تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم
تعليم جديد أخبار و أفكار تقنيات التعليم